كيف للمكان أن يشتاق للمكان؟ في غزة الإجابة، حين لا يعود هو نفسه، حين يختفي عن وجه الأرض، ويبقى عبارة عن خيالات في الذاكرة، حين تبحث عنه في صورٍ قديمة، أو في مقاطع فيديو تمرّ عليك في وسائل التواصل الاجتماعي، فتتذكر؛ هنا حين أخذتني عائلتي للتنزه، وهنا حين لعبت مع أصدقائي بعد المدرسة، وذاك الشارع حيث اشتغلت في الصيف، وهذا المطعم عزمت عليه عائلتي مع أول راتب، وهنا وهنا وهنا..
تتذكر ولا تجد حولك سوى الركام وأطنان الأنقاض حتى أنّك تمشي ولا تعرف أن تحدد مكان بيتك بالضبط أو جامعتك، ليس كالحروب السابقة دائمًا كانت تبقى علامة ما، الآن كل شيء تدمر من عمود الكهرباء إلى الشجرة، ومن المسجد حتى محطة البنزين.
هل يشتاقون إلى البحر أم إلى شارع عمر المختار، وربما إلى رائحة العطارة في سوق الزاوية، وازدحام مخبز العائلات قبيل آذان المغرب في رمضان، أو جنة الفراولة في بيت لاهيا، وربما إلى شجرات الزيتون في بيوت الجدات، إلى ماذا يشتاق أهالي غزة بعد عام من الحرب؟
كم مرة تهّدمت غزة وبنيناها؟ كم مرة تغيّرت جغرافيتها وتغيّرنا معها كي نعيش من جديد؟ كم مرة هُدمت أماكننا وبدلناها؟ كم مخططًا معماريًا سنرسم؟ وكم فضاءً جديدًا سنملأ من جديد بالأبراج والمباني والمدارس والمستشفيات؟ نبني ويهدمون، ويهدمون ونبني، نيأس ويعود الأمل، ثم نيأس لوقت أطول في حرب أقسى وركام أكثر والآن ننتظر الأمل، ويعود القطاع الذي نحب، تعود الأماكن التي شهدت سنواتنا كلها، طفولتنا، جامعتنا وحبنا الأول، مشاكلنا الأولى وشغلنا الأول، الأماكن هي عائلتنا وضحكاتنا وأصدقائنا وذاكرتنا، وذاكرتنا هي هويتنا.
تغيّر الشارع، لم يعد هناك شارع بالأساس، أعتقد كان هناك ميدان، وهنا بقالة، وعلى الناصية صالة أفراح دائمًا كان أمامها زفة والكل يرقص، والزغاريد تصعد مع الهواء، وهنا كنت أسكن، أتلصص النظرات إلى فرح الناس، حالة النشوة الجماعية التي لم يكن أحد يعرف أنها ستتحول لهيستريا بكاء وصراخ جماعي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، من العام المنصرم.
بعد عام على الحرب ماذا يقول أهالي القطاع عن أماكنهم؟ يا ترى أيّ الأماكن التي يشتاقون لها وغابت للأبد إلى أن يقرر العالم إعادة الإعمار، وحينها لن يعود أي شيء كما كان، وسنكون غرباء في وطننا مرة أخرى.
هل يشتاقون إلى البحر أم إلى شارع عمر المختار، وربما إلى رائحة العطارة في سوق الزاوية، وازدحام مخبز العائلات قبيل آذان المغرب في رمضان، أو جنة الفراولة في بيت لاهيا، وربما إلى شجرات الزيتون في بيوت الجدات، لأولئك الذين نعرفهم، ولا نعرفهم، وربما نشتاق لكل ما راح والأهم لما كنا نحن عليه. في هذه المادة، كان من الأسهل ترك أهالي غزة يتحدثون، عن حنينهم الطازج للأماكن في غزة.

- آمنة سليمان، في العقد الرابع من عمرها، معلمة رياضيات، تعيش في جباليا، شمال قطاع غزة، ونزحت في أحياء جباليا عدة مرات حتى عادت إلى منزلها هناك.
"أشتاق إلى قبر أختي كفاح جرّفه الجيش الإسرائيلي من مقبرة الفالوجة، ولم نعد نعرف مكانها، وقد توفيت خلال الحرب بعد أن أصابتها جلطة دماغية ولم نجد مستشفى يعالجها، كما أشتاق إلى بيت خالتي هدى، استشهد فيه 65 شهيدًا، منهم أختي هنادي وابنها عوض وزوجها إبراهيم، أشتاق إلى أشجار البرتقال والليمون في بيّارتي التي دمرتها دبابات الاحتلال في جباليا أيضًا، أما الأماكن العامة فأشتاق جدًا للشارع الممتد أمام البحر والكورنيش، شارع الرشيد، كذلك أفتقد مشاهدة المناسبات الثقافية داخل مبنى رشاد الشوا الذي دمرته طائرات الاحتلال وسط مدينة غزة، وأشتاق للتسوق في سوق مخيم جباليا، وفي سوق البسطات بالشجاعية، لكن كل شي راح، وراحوا الحبايب".

- أدهم عاشور، 37 عامًا، كان يعمل مندوب مبيعات، وحاليًا نازح من منطقة الكرامة شمال قطاع غزة إلى وسط قطاع غزة.
"أشتاق لكورنيش منطقة الشيخ عجلين، كان المتنفس الوحيد لي، حين أزور البحر بعد أن أسرق يومًا من أيامي التي كانت كلها شغل في شغل، وضغوط الحياة والأولاد، فكنت أركب مواصلتين من الكرامة للكورنيش، وأجلس هناك أتأمل البحر وأعود خاليًا من الهموم".

- كريم أبو ضاحي، 37 عامًا، محامٍ، نزح من مدينة غزة إلى رفح قبل أن يسافر إلى مصر مضطرًا بعد تهديد اجتياح رفح.
"كانت من طقوسي التي لم أتوقف عن ممارستها، هو المشي مع صديقي بلال في شوارع مخيم الشابورة برفح، كلانا من مواليد هذا المخيم، عشنا سنوات طفولتنا الأولى هناك، ورغم مرور السنوات إلا أنّ زيارتنا للشابورة ثابتة، المشي هناك كان يسافر بنا عبر الزمن إلى سنوات التسعينات، كنّا نشعر وكأننا نمشي في بيتنا، نلقي التحية على جيراننا القدامى، يستقبلونا بود بات مفقودًا في زماننا هذا".
"في رفح تحديدًا، تشعر أنّ كل شيء فيها يخصّك، كل زاوية فيها تعرفك، تربطك علاقة مع الأشياء، كلها، بيتك القديم، أولاد حارتك، سوق المخيم، كل شيء هنا يرّحب بك بحفاوة. وفي شهر رمضان تحديدًا، كنا نذهب أنا وبلال من بعد العصر إلى الشابورة، نشتري الكنافة من أبو رنا، أشهر بائع كنافة في رفح، ثم نذهب للسوق ونشتري الجرجير، والفلافل المحشي الذي تجبرك رائحته على أن تشتريه، كان بلال يمازحني حينها: بربك إيش طابخين؟ أقول له مقلوبة، فيضحك ويقول وشاري فلافل محشي؟ نضحك كثيرًا، وأقول: نحن نشتري الرائحة، وقبل المغرب بدقائق نغادر الشابورة بعد أن نأخذ حصتنا من الفرح كاملة".
"اليوم أفكر هل نستطيع فعل هذا الأمر ثانية؟ بمعنى آخر، ماذا فقدنا في طريقنا؟ نحن فقدنا منتزه النجمة، وبيوت المخيم، وشوارعه، لن نشتري الكنافة من أبو رنا، حيث توفي خلال هذه الحرب من شحّ الأدوية ونقص الرعاية الطبيّة، سوق المخيم أيضًا ذهب دون عودة، ولن نجد أولاد حارتنا لكي نحييهم، ولم يعد لدينا حارة، لقد فقدنا الطريق كلها. أصعب شيء ممكن عمله أنْ أكتب عن مكان واحد؛ لأنه حتى الآن لا أعرف ماذا فقدت، خسارتنا لا أستطيع أن أحصيها، أكيد بتعرفي جملة درويش ’لا شيء يوجعني في غيابك، سوى الكون’، وهذا حالي".

- غالية حمد، في العقد الثالث من عمرها، مراسلة الجزيرة مباشر، نزحت عدة مرات من مدينة غزة مع طفلتيها وزوجها، حتى وصلت إلى مدينة دير البلح، ثم سافرت مع عائلتها خارج القطاع.
"للمدن الكبرى همومها وضغوطاتها، فكيف لو كانت محاصرة قلقة كغزة! كانت كلما ألقت بأعبائها ومشاكلها اليوميّة البسيطة على روحي أجد نفسي وقد استقطعت يومًا أهرب فيه من كل شيء.. إلى حيث بدأنا وسننتهي، إلى الطبيعة الجميلة التي تحارب لتبقى في واحدة من أكثر الأماكن المكتظة في العالم. والطبيعة وجمالها في قطاع غزة تتجسّدان في المناطق الحدودية التي كان الأهالي يستغلّونها في الزراعة فبقيت كمناطق عذراء لم يدنس أحد جمالها، يكفي أن أتجه شمالًا لأصل لحقول الذهب الأحمر في بيت لاهيا لأنسى كل ما يشغل قلبي وعقلي، فأضيع بين جمال المساحات الخضراء الممتدة وبين الآثار التي تكاد تنطق بالحقيقة وبين صفاء البحر الذي تنام أمامه هذه المدينة الجميلة".
"كنت وعائلتي كلما عدنا إلى بيتنا لا نختار طريقًا مختصرًا يوصلنا عبر شارع الجلاء إلى مشروع بيت لاهيا، بل نسلك طريقًا كنت أسميه رأس الرجاء الصالح.. يصرّ فيه زوجي ولا أعارضه على أن نتجه حتى أقصى نقطة عبر شارع الرشيد شمالًا لنرى جمال الطبيعة ونتنفس هواءً نظيفًا مميزًا يرد الروح، قالوا لي بأنّ كل هذا الجمال كان أول ما دمره الاحتلال وشوهه، لا أسمح لنفسي بثانية واحدة تخيل أنني لن أتمكن يومًا من العودة و التنزه مع طفلتي في هذه الطبيعة الساحرة، لا أتخيل أنّ أهالي بيت لاهيا لن يوقفوني من جديد ليقدموا لي فنجانًا من القهوة اللذيذة المعدّة على نار الحطب أو حفنة من الفراولة الألذ في العالم، وأني لن أرى ابتساماتهم اللطيفة لكل مار، لا أريد أن أصدق أني لن أسمع ضجيج مواتير المياه القديمة وهي تغذّي الأقنية الصغيرة فتضخّ الحياة إلى الحقول التي تقاوم الاجتثاث الإسرائيلي لها كل يوم، هذه من اللحظات التي يتمنى فيها المرء لو أقفل الباب على الذاكرة فلا تستقبل أي تحديث جديد.. لأنّ استيعاب أن أحدًا على هذه الأرض قادر على تجريف وإحراق كل هذا الجمال هو مما يفوق مقدرتنا البشرية".

- ساري الحسنات، 33 عامًا، لاجئ في ألمانيا منذ خمسة أعوام، باحثًا على مستقبل أفضل.
"الحرب دمرتني كما دمرت ذاكرة المكان والمدينة، أراقبها من شاشات الأخبار، وأشتاق إلى مخيم جباليا وخاصة حارتي، يحتلان جزءًا كبيرًا من تفكيري، حيث الكثير من البيوت التي كنت أجلس بداخلها وعلى أبوابها مع أصدقائي؛ كنا نصنع السعادة بالمرح وننفض عن قلوبنا الملل، لقد دُمرت الآن مع ساكنيها من قبل الطائرات. الشوارع أخذت نصيبًا كبيرًا من الوجع إذ صار بعضها بيوتًا للجثث والركام وخاصة الشارع الطويل الذي كان يأخذني إلى البحر انطلاقًا من دوار أبو شرخ إلى المتوسط وزرقته التي كانت تمنح الزائرين آمالًا غير متوقعة، أتذكّر تلك اللحظات التي كنت أركض مع أصدقائي بهذا الطريق ونمشي معًا فيه ونستمع إلى الأغاني ونتحدث كثيرًا عن أحلامنا التي لا نعرف أين هي الآن".
"حين شاهدت الصور التي التقطها الأصدقاء وبعض المصورين لمخيم جباليا بشوارعه وبيوته في الحرب الحالية، أصابتني صدمة كبيرة؛ لأنني عجزت عن تحديد الأماكن التي تجولت بها كثيرًا قبل أن أغادر غزة للمرة الأولى عام 2018. كنت أتمنى أن أزور غزة وألتقي بالأهل والأصدقاء وأستعيد معهم الذكريات، لكن حلمي مات بموت الأماكن والكثير من الأرواح التي اعتدت على مشاهدتها.. أشتاق إلى محلات الألبسة والمطاعم والأسواق، وقد التهمتها نيران القذائف، وبات الناس في مهبّ الجوع ورهائن للثياب المهترئة. أتساءل دومًا؛ هل من رحلوا من الأصدقاء والأقارب ما زالوا أحياء وكل ما في الأمر أنني مغترب وهم كما هم ما زالوا يمارسون حياتهم وحين أعود سألتقي بهم مجددًا؟".

- محمد دولة، 42 عامًا، سائق تاكسي، نزح عدة مرات داخل مدينة غزة، ولا يزال صامدًا هناك مع أطفاله وزوجته.
"أشتاق لمنطقة تل الهوى، كنت أعيش هناك، مكان حلو كثير وهادئ، وكان كل شيء قريب علينا، وشو ما نحتاج موجود، والبحر قريب علينا، وشغلي في مكتب سيارات قريب منا..آآخ قول للزمان إرجع يا زمان، كانت أيام عز وخير، صحيح كنا عايشين على قد الحال بس مع ذلك كنا بخير ونعمة كبيرة، والحرب بجد حرمتنا من أشياء كثيرة".

- نهيل مهنا، في العقد الرابع من عمرها، كاتبة وقاصة، نزحت داخل مدينة غزة عشرات المرات، هاربة من الموت، بصحبة ابنتها، ولا تزالان صامدتين هناك.
"أشتاق إلى غزة وأنا داخل غزة؛ لأن ذكرياتنا راحت ومن نحبهم تركوها وتركونا، هذا جعل كل شيء ناقص، كما أشتاق إلى النادي حيث كنت أتمرن، وإلى مطعم الديرة على البحر، حتى لو الأماكن رجعت فكرك الناس وحبايبنا راح يرجعوا وترجع قعداتنا؟ إذا عنوانك الأماكن كلها مشتاقة لك.. فأنا أقولها لأخواتي وأصدقائي وزملائي في العمل، ولراحة البال الأماكن مشتاقة لكم، غزة مشتاقة لكم".

- أحمد جهاد آل الشيخ، 37 عامًا، صحفي، نزح داخل مدينة رفح عدة مرات، إلى أن وصل خانيونس.
"أشتاق إلى مفترق السرايا قلب مدينة غزة، كان يمثّل نقطة التقاء حيوية، كما يعجّ بالأماكن والمؤسسات والمقاهي، ويعكس الحياة اليومية للمدينة، يتجمع المواطنون فيه من كل مدن القطاع بسبب توقف سيارات الأجرة هناك، كان مليئًا بالنشاط والحيوية. كل زاوية تحمل ذكريات جميلة من العمل والحياة اليومية، فكان يمثل نقطة الوصول والمغادرة من وإلى مدينة غزة، وكان مكان عملي قريبًا جدًا منه. أما دوار النجمة فهو رمز مدينة رفح، وواحد من أجمل المعالم فيها، ملتقى شوارع المدينة الرئيسة، ومدخلها، وواحد من أكبر أماكن تجمع المرافق، كان يمثّل نقطة الترفيه الأكبر لأهالي المخيمات القريبة، خاصة في فصل الصيف وقت انقطاع الكهرباء، لذا يضجّ المكان بعشرات المقاهي والمطاعم والمحال وأصبح ملاذًا لآلاف المواطنين. أتذكر كيف كان الأطفال يلعبون حوله، بينما الكبار يتبادلون الأحاديث. لكن الآن، مع الدمار الذي خلّفته الحرب، أصبح مفترق السرايا ودوار النجمة يفتقران للحياة والبهجة، لم يترك الاحتلال أيّة معالم، سوى الخراب. هذان المكانان مثلًا جزء من حياتي، دوار النجمة مكان نشأت قربه في مخيم الشابورة، ومفترق السرايا أصبح جزءًا من يومي، فعملي بالقرب منه، وفقدانهما هو خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها".

- إيهاب شحادة، 36 عامًا، موظف حكومي، نزح من داخل مدينة غزة عدة مرات حتى وصل إلى وسط قطاع غزة.
"أشتاق إلى الجامعة الإسلامية، أحبها وأفتخر بها؛ لأني درست بها وهي صرح فلسطيني تعليمي متميز وواجهة حضارية، لكنها راحت. أما معبر رفح كان حلمًا للخروج من ظلام الوضع حتى من قبل الحرب وراح أيضًا، أشتاق للمسجد الغربي بمخيم الشاطئ كثيرًا فقد كنت أصلي به منذ طفولتي، وحفظت فيه القرآن كاملًا وكنت إمامه فترة، كما اعتدت أن أقابل فيه أصحابنا وجيراننا من أهل الحي وصحبة المسجد الجميلة، وكان إسماعيل هنية حتى وقت ليس ببعيد جدًا هو إمام المسجد، وتربينا على صوته ودروسه هناك، كلها من عبق الذكريات راحت أيضًا".
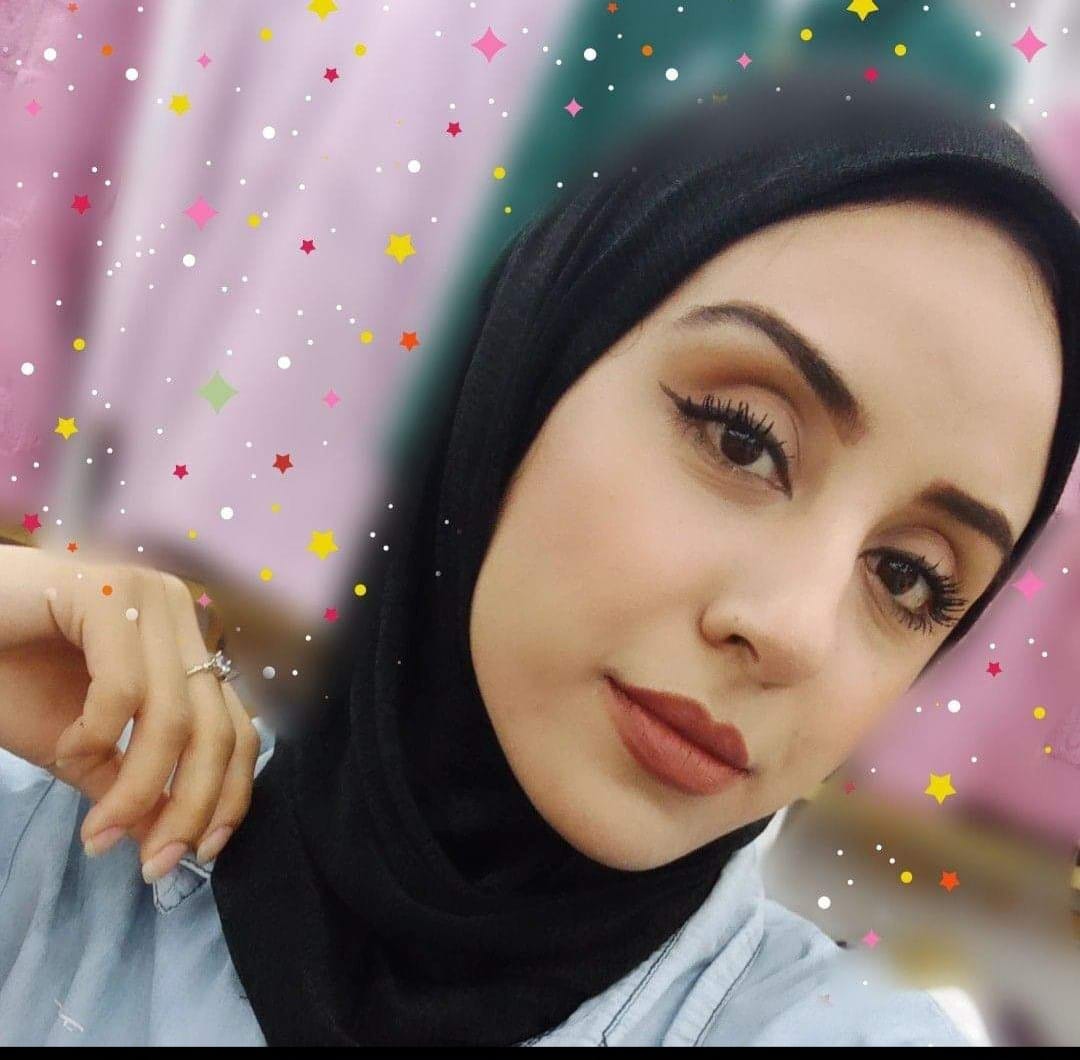
- عبير أحمد، في العقد الثالث من عمرها، ممثلة مسرح، نزحت من جباليا شمال قطاع غزة، إلى عدة أماكن حتى وصلت خانيونس في جنوب القطاع.
"أشتاق إلى شارع أو بالأصح بمصطلحات المخيم هو زقاق بيتنا في مخيم جباليا، الذي أصبح الآن كومة كبيرة من الحجارة والبيوت المهدمة، كان هذا الطريق يؤدي إلى بيتي الذي قضيت فيه عمري، رائحة أزهار وأشجار أمي نستطيع شمها منذ بداية الزقاق، كنا نهتم بتفاصيله كأنه ركن من أركان البيت يجب أن يكون نظيفًا دائمًا ومزروعًا بالشجيرات الصغيرة، حتى جدرانه كانت تُدهن بألوان فاتحة كي يعطي طاقة إيجابية للزائرين، وزوار والدتي كثر".
"الآن لا أتخيل أن أعود إلى بيتنا في مخيم جباليا ولا أستطيع أن أشم رائحة شجرة ’ليلة القدر’، ولا أمشي في هذا الزقاق الذي يؤدي إلى بيتي فلا أجد حتى بيتي، فكلها أماكن غدت، كأنها لم تكن يومًا. أشتاق أيضًا إلى مركز رشاد الشوا الثقافي، وأريد حقًا أن أرثيه كأنه أحد أصدقائي، هذا المكان الذي احتضنَ وقدّم كل شيء جميل لأهالي قطاع غزة، وقد عَرضتُ هناك أجمل أعمالي المسرحية على خشبته، وتعرفت على أفضل الشخصيات والأصدقاء من خلاله، شاهدت أجمل العروض الفنية بين جدرانه، بكينا وضحكنا معًا، حتى شكله الهندسي كان لا يشبه شيئًا آخر في عمارته، كان في قلب المدينة، كان حقًا نبض كل الأشياء الجميلة في غزة، فقتلوه! أي خسارة هذه يا الله!".

- مؤمن حسونة، 30 عامًا، عامل، نزح عشرات المرات، بصحبة أطفاله وزوجته داخل مدينة غزة هروبًا من القصف الإسرائيلي والاجتياحات، ولا يزال صامدًا هناك.
"أحنُ إلى أماكن كثيرة في غزة خاصة مستشفى الشفاء، كان أكثر مكان زعلت على تدميره، وحتى اللحظة لا أصدق أنه غاب نهائيًا، وتقديري أنه لن يعود يومًا كما كان، وقبل الحرب عملت بائعًا متجولًا في المشفى وفي الحرب نزحت إليه مع عائلتي، وبقيت أيضًا أبيع الشاي والقهوة، لذلك تراكمت الذكريات فيه، خاصة ذكرياتي الأولى مع رحلة علاج والدي الراحل قبل حوالي العامين، وكنت أحب المشفى في فصل الشتاء خاصة.. أتناول أكلي في الاستراحة، وكل أبناء الشعب هناك لا فرق بينهم على عكس خارجها، كما كنت أحب منطقة تل الهوى وكل ما تشتهي من أكل ولبس ومقاهي وحدائق تجده هنا، لكن تحولت الآن إلى تل الدمار".

- شيماء أبو حمدة، في الثلاثينات من عمرها، مترجمة، نزحت عدة مرات داخل مدينة غزة من حي الرمال لحي الزيتون والعكس، وصامدة حتى الآن.
"أشتاق إلى مطعم نابوليتانا… مطعم صغير بمكان مفتوح وحوالينا شجر، مقابل الكتيبة عند منطقة الجامعات، أكله لذيذ وغير معتاد بطريقة البيتزا والعجين كأنه فعلًا قطعة من نابولي، ولي ذكريات حلوة في المكان مع بنات أخي، تحول الآن المكان لخراب، كله غربان وكلاب ضالة وهزيلة وحفر بأقطار مختلفة، ذكريات لن تتكرر.. انتهت للأبد. أما المكان الثاني هو حمام السمرة، مع إني ولا مرة دخلته بس كنت بعرف مدى أهميته تاريخيًا وكنت أمني نفسي أني راح أدخله يومًا ما وأتحول للسلطانة هويام، تخيلي موقع أثري صار دمارًا، أثرًا بعد عين! وانحرمت من تجربة المكان للأبد! والمكان الثالث هو الكورنيش وشارع الرشيد، لما أمشي فيه أحس إني في بلد ثاني، شارع ممهد ومسفلت ونظيف يمتد على طول امتداد البحر، تحسّ على وجهك نسمات الصيف، أفتقد مراجيح الخشب الكبيرة المثبتة على شاطئ البحر، وكنا نلعب عليها منذ طفولتنا. الآن صار شارع الرشيد كابوسًا من كثر ما رأيت صور ناس ماتت عليه وهي تحاول الهرب من القصف، حتى البحر صار مرعبًا. اختفاء كل الأماكن هذه دليل على أنه تشردنا وراح نضل نعيش حالة اغتراب طول ما أحنا في وسط هذا الخراب".

- بهاء أحمد، 36 عامًا، مهندس كهربائي، نزح أكثر من أربع مرات داخل خانيونس ومن ثم إلى رفح، قبل أن يسافر بعدها إلى مصر.
"أنا نشأت وولدت في هذه المدينة الجميلة خانيونس، وتعلمت في الجامعة الإسلامية بغزة وتحقق حلمي وأصبحت مهندسًا كهربائيًا، عملت مهندسًا في عديد من المشاريع السكنية التي خدمت أهالي القطاع، وساهمت ببناء أبراج مدينة حمد في خانيونس، وأصبحت أحد سكّانها، إلا أنني لم أتوقع يومًا أن ما بنيته وتعبت من أجله سيتم تدميره ولن أستطيع السكن فيه مرة أخرى، هذا ما حدث حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الحرب أغلبية مباني وأبراج مدينة حمد وأصبحت ركامًا، وأخذت معها الذكريات الجميلة وسنوات الشقاء والعناء في تحقيق أحلامي، مدينة حمد كانت من أجمل المدن عمرانًا وجمالًا التي بنيت مؤخرًا في قطاع غزة، ولا تغيب عن بالي لحظة في الصحو والمنام".
